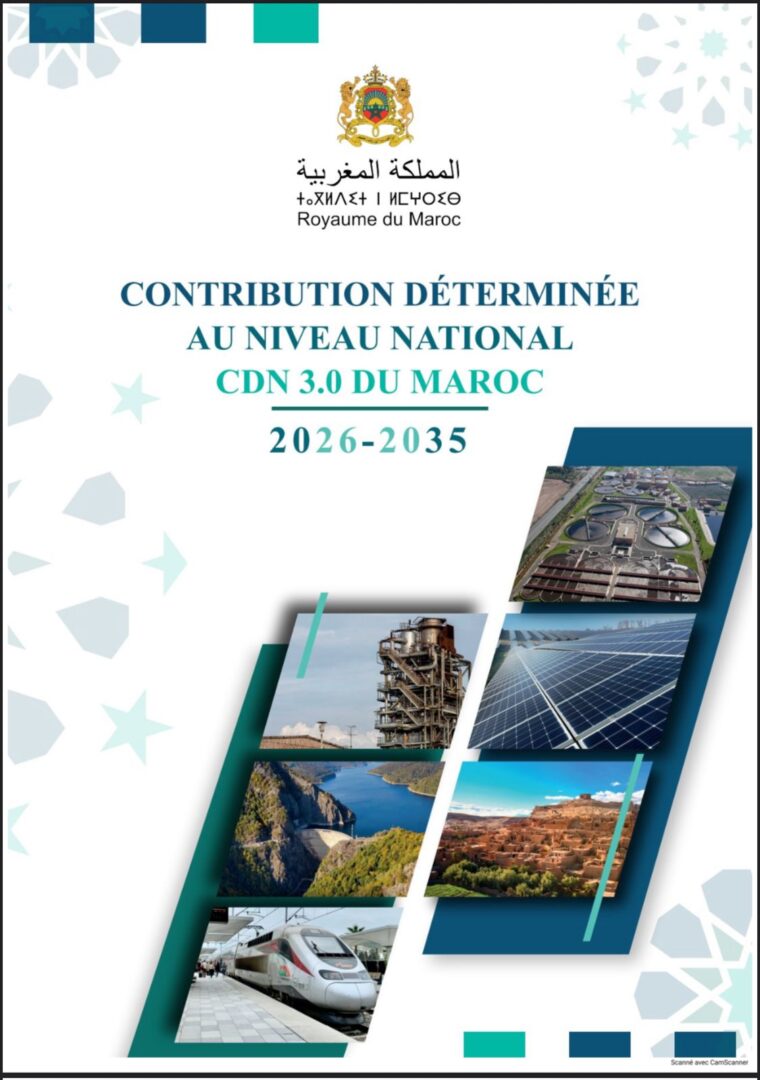تعزيز الانتقال المناخي والرقمي الشامل في المنطقة العربية: جدول أعمال من أجل انتقال عادل
تقف المنطقة العربية عند لحظة مفصلية وهي تخوض تحولَين بنيويين عميقين: الأول يتمثل في الانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون استجابة لتغير المناخ، والثاني في التحول الرقمي المتسارع الذي يُعيد تشكيل الصناعات والمجتمعات. ورغم ما يحمله هذان التحولان من وعود هائلة لتحقيق التنمية المستدامة، إلا أنهما يطرحان في المقابل تحديات عميقة تتعلق بأسواق العمل، والعدالة الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي. وإدراكًا لحجم الرهانات، أنشأ الاتحاد العربي للنقابات (ATUC) المركز العربي للانتقال العادل كمبادرة مكرسة لضمان نهج قائم على الحقوق والشمولية في إدارة هذين التحولين. واستلهم المركز رؤيته من الجهود العالمية التي يقودها الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، واضعًا نصب عينيه ضمان أن تمر التحولات المناخية والرقمية في الاقتصادات العربية بطريقة "تحمي مستقبل وسبل عيش العمال ومجتمعاتهم" من خلال الحوار الاجتماعي والعدالة.
يقدم هذا التقرير، المصاغ على نمط تقارير الأمم المتحدة، قراءة تحليلية لمنهجية المركز وسياقه الأوسع، موجّهًا إلى جمهور من المنظمات الدولية والنقابات. ومع دخول عقد العشرينيات، أصبح من الجلي أن "الانتقال العادل ليس مجرد شعار، بل هو إطار للحقوق والمسؤوليات"، كما أكدت عليه الحركة النقابية العالمية. وفي ظل ما تشهده المنطقة من تفاقم لتأثيرات التغير المناخي وتسارع الرقمنة في مرحلة ما بعد الجائحة، تزداد الحاجة إلى مفهوم الانتقال العادل إلحاحًا. ويعمل المركز العربي للانتقال العادل كمحور إقليمي ضمن مظلة الاتحاد العربي للنقابات، ليُسهم في إدماج صوت العمال في السياسات المناخية والرقمية، ويُعزز الحوار الاجتماعي، ويوثق الممارسات الفضلى، ويمثل العمال العرب في المنتديات الدولية. ويرتكز عمل المركز على مبدأ جوهري: أن كِلا التحولين — المناخي والرقمي — يجب أن يُدارا وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، ما يعني أنهما يجب أن يكونا شاملين، وتشاركيين، ومترسخين في حماية الحقوق العمالية. وتستعرض الفصول التالية من هذا التقرير تحليلًا لتقاطع هذين التحولين في اقتصادات المنطقة العربية، وتأثيراتهما على أسواق العمل، والمحاور السياساتية الرئيسية لضمان عدم استثناء أحد من هذه المسارات.
التحول المزدوج في المنطقة العربية: التقاطع بين المناخ والرقمنة
التحول المناخي تواجه الدول العربية تحديات متزايدة تدفعها نحو التحول إلى اقتصادات مستدامة ومنخفضة الكربون. ويعود ذلك من جهة إلى الواقع المناخي القاسي — حيث تُعد المنطقة من أكثر المناطق هشاشة في العالم في مواجهة تغير المناخ، بما يشمل موجات الحرارة، والجفاف، ونقص الموارد — ومن جهة أخرى إلى الضرورة الاقتصادية في ظل تراجع الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري. ولا تزال العديد من الاقتصادات العربية، خصوصًا دول مجلس التعاون الخليجي، تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، مما يجعل الحاجة إلى التنويع الاقتصادي والاستثمار الأخضر أمرًا بالغ الأهمية.
وفي هذا الإطار، تُظهر أبحاث جديدة صادرة عن منظمة العمل الدولية وشركائها أنه إذا تم اعتماد سياسات مناخية وصناعية قوية، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن تخلق ما يصل إلى 10 ملايين وظيفة جديدة بحلول عام 2050، مع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.2%. وقد تم تقديم هذا السيناريو الإيجابي خلال مؤتمر الأطراف COP28 عام 2023، حيث تم التأكيد على ضرورة تطوير الطاقة المتجددة (كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، والصناعات الخضراء (مثل الوقود الهيدروجيني)، والبنية التحتية المقاومة للمناخ. ومن الأمثلة البارزة: الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه المستدامة، وإعادة التشجير، وإدارة النفايات — وهي كلها قطاعات يمكن أن توفر مسارات "لا تترك أحدًا خلف الركب" إذا ما اقترنت بسياسات اجتماعية عادلة.
لكن هذا التحول المناخي يحمل أيضًا في طياته اضطرابات. فالعمال في الصناعات كثيفة الكربون (كالنفط والغاز والبتروكيماويات)، وفي القطاعات المعرضة لتقلبات المناخ (كالزراعة والصيد البحري)، يواجهون غموضًا بشأن مستقبلهم المهني. ويؤكد المركز العربي للانتقال العادل أن استراتيجيات إزالة الكربون يجب أن تُصاغ بالتوازي مع خطط بديلة للتوظيف، وبرامج إعادة تدريب، وآليات للحماية الاجتماعية. وتشدد منظمة العمل الدولية على ضرورة أن تُرفق السياسات الخضراء بإجراءات داعمة "لجميع المتأثرين بها، دون استثناء"، معتبرة أن الانتقال العادل ضرورة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
وفي الدول المنتجة للنفط، يعني ذلك إشراك العمال المحليين والعمال المهاجرين في حوارات حول مستقبل العمل في سياق تنويع الاقتصاد. أما في الدول غير النفطية، فإن الاستفادة من فرص الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يمثل فرصة حقيقية لتوليد وظائف جديدة. وتشير استثمارات المغرب ومصر والإمارات في مشاريع الطاقة النظيفة واستراتيجيات الحياد الكربوني إلى وجود إرادة سياسية متنامية لربط أهداف المناخ بالتنمية. ويُبرز تقاطع هذه الجهود الحاجة المُلِحّة إلى إشراك النقابات العمالية في جميع مراحل صنع القرار، لضمان أن يُفضي العمل المناخي إلى فرص عمل لائقة وعدالة اجتماعية التحول الرقمي بالتوازي مع التحديات المناخية، تشهد الاقتصادات العربية تحولًا رقميًا جذريًا يُعيد تشكيل أنماط التجارة، والاتصال، والعمل. ففي العقد الأخير، ارتفع معدل الاتصال بالإنترنت في المنطقة من 28.8% من السكان عام 2012 إلى أكثر من 70% في عام 2022، ليصل عدد المستخدمين إلى نحو 327 مليون شخص.
وقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تسريع المبادرات الرقمية الحكومية، مثل تحديث الخدمات الإلكترونية، وتشجيع نماذج الأعمال القائمة على الإنترنت. ومع ذلك، لا تزال الفجوة الرقمية تمثل تحديًا جوهريًا، إذ إن نحو 30% من سكان المنطقة — أي ما يُعادل 142 مليون شخص — لا يزالون غير متصلين بالإنترنت حتى عام 2021. وتبرز هذه الفجوة بشكل خاص بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض، وبين المناطق الحضرية والريفية، وكذلك بين الجنسين: إذ تستخدم 56% فقط من النساء الإنترنت مقابل 68% من الرجال.
وتعني هذه التفاوتات في البنية التحتية الرقمية والمهارات أن شرائح كبيرة من المجتمع تواجه خطر الإقصاء من التحول الرقمي. فعلى الرغم من أن الاقتصاد الرقمي يفتح آفاقًا جديدة للتوظيف، كفرص العمل الحر والعمل عبر المنصات التي يستفيد منها العديد من الشباب، إلا أن هذه الوظائف غالبًا ما تقع في القطاع غير الرسمي أو شبه الرسمي، دون ضمانات قانونية أو اجتماعية كافية.
وفي الواقع، تُظهر توقعات منظمة العمل الدولية لعام 2024 أن العمال على المنصات الرقمية "لا يتمتعون عادةً بأمان وظيفي تقليدي، أو بمزايا، أو بحماية قانونية على غرار الوظائف الرسمية". كما أن التباين بين المهارات المطلوبة في سوق العمل وتلك المتوفرة لدى الباحثين عن عمل — خاصة في المجالات الرقمية والتكنولوجية المتقدمة — يشكل تحديًا مستمرًا. فقد أخفقت المناهج التعليمية وبرامج التدريب المهني في مواكبة التغيرات التقنية السريعة، ما ترك العديد من الخريجين دون مهارات رقمية ملائمة لسوق العمل. وإذا لم تتم معالجة هذا القصور، فإن التحول الرقمي قد يُفاقم من عدم المساواة، بحيث يستفيد من يملك الاتصال والمهارات المتقدمة، بينما يتعرض الآخرون للتهميش.
ولهذا، يُؤطر المركز العربي للانتقال العادل الإدماج الرقمي بوصفه قضية جوهرية في تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يعتبر أن ضمان الوصول الميسور إلى الإنترنت، ونشر الثقافة الرقمية، وحماية العمال في الاقتصاد الرقمي — جميعها عناصر أساسية ضمن جدول أعمال الانتقال العادل. تقاطع التحولين: المناخي والرقمي غالبًا ما تتم مناقشة التحولين المناخي والرقمي بصورة منفصلة، إلا أن واقع الأمر يُظهر أنهما متشابكان بعمق في تأثيراتهما الاقتصادية والاجتماعية. فكلاهما يعد بإحداث تحديث هيكلي، وخلق صناعات جديدة — من مزارع الطاقة الشمسية إلى المدن الذكية — وكلاهما يعتمد على قوة عاملة ماهرة ومتمكنة. ويمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تُسرّع من تنفيذ الحلول المناخية، مثل الشبكات الذكية، والرصد عن بُعد للزراعة، أو أنظمة النقل العام الفعالة. وبالمقابل، فإن الاقتصاد الأخضر سيولّد طلبًا على العمالة الماهرة تقنيًا، مثل المهندسين في قطاع الطاقة المتجددة، أو محللي البيانات في كفاءة الطاقة. علاوة على ذلك، فإن هذين التحولين يحدثان بشكل متزامن، ما يُنتج ضغوطًا مركّبة على الدول العربية لتكييف أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية. فمثلًا، قد يتأثر عامل في مصفاة نفط بسياسات إزالة الكربون، وفي الوقت نفسه بالأتمتة الرقمية في قطاع التصنيع. وقد يحتاج خريج جامعي شاب إلى مهارات خضراء ورقمية معًا ليتمكن من الانخراط في أسواق العمل الجديدة. هذا التقاطع يُحتم على الدول العربية تطوير استراتيجيات شاملة تعالج التغيرات المناخية والرقمية بشكل مترابط، لا في معزل عن بعضهما البعض. وهذا بالتحديد هو المجال الذي يسعى المركز العربي للانتقال العادل إلى إشغاله: الربط المنهجي بين الاستدامة البيئية والابتكار التكنولوجي تحت مظلة العمل اللائق والتنمية العادلة. ومن خلال الترويج للسياسات المتكاملة — كالدعوة إلى دمج برامج رفع الكفاءة الرقمية في الخطط المناخية الوطنية، أو تضمين استراتيجيات الاقتصاد الرقمي لأهداف خلق وظائف خضراء — يُبرز المركز وشركاؤه أن مستقبل الاقتصاد في العالم العربي يجب أن يكون أخضرًا، رقميًا، عادلًا، وشاملًا
اتجاهات سوق العمل والتحديات الاجتماعية في المنطقة العربية
شهدت أسواق العمل في المنطقة العربية ضغوطًا هيكلية حتى قبل بدء التحولين المناخي والرقمي، واليوم تتفاقم هذه التحديات مع تسارع وتيرة التغير. فلا تزال معدلات البطالة مرتفعة بشكل مزمن، حيث بلغ متوسط البطالة في المنطقة 9.8% في عام 2024، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي، ولا يزال يفوق المعدلات المسجلة قبل جائحة كوفيد-19. وتُعد بطالة الشباب من بين الأشد حدة عالميًا، إذ تتجاوز 20% في العديد من الدول العربية، كما تُسجَّل أدنى معدلات لمشاركة النساء في القوى العاملة على مستوى العالم. وتشير التقديرات إلى أن الفجوة الجندرية في سوق العمل لا تزال قائمة، ليس فقط في نسب التوظيف، بل أيضًا في الأجور، ونوعية الوظائف، وفرص الترقّي المهني. وفي تقريرها الأخير حول آفاق التشغيل في الدول العربية، تُرجع منظمة العمل الدولية هذا النقص في فرص العمل إلى عوامل هيكلية، تشمل التقسيم الواضح في أسواق العمل بدول الخليج بين وظائف القطاع العام للمواطنين والقطاع الخاص للعمالة الوافدة، إضافة إلى ضعف القطاعات الخاصة، وانعدام الاستقرار السياسي والنزاعات في العديد من الدول غير الخليجية.
والنتيجة هي أن الاقتصادات العربية لا تولد ما يكفي من الوظائف اللائقة والمرتفعة الجودة لاستيعاب النمو السريع في عدد السكان ضمن سن العمل. إحدى أبرز خصائص سوق العمل في المنطقة هي حجم الاقتصاد غير المنظم، حيث يُقدّر أن أكثر من نصف العاملين العرب يشتغلون في وظائف غير رسمية أو غير مستقرة، دون حماية اجتماعية أو تأمينات. وتشير بيانات عام 2023 إلى أن نحو 7.1 ملايين عامل — أي ما يُعادل 12.6% من إجمالي العمالة — يعيشون في فقر ناتج عن العمل، ما يعكس اتساع رقعة العمالة المنخفضة الأجر وغير المستقرة.
ويعمل هؤلاء العمال غالبًا في قطاعات مثل الزراعة، والبناء، والتجارة الصغيرة، وخدمات التوصيل، وهم عادةً يفتقرون إلى العقود، أو التأمين الصحي، أو خطط التقاعد. وفي سياق التحولين المناخي والرقمي، فإن هؤلاء هم الأكثر عرضة للمخاطر: فهم أول من يتأثر بالصدمات الاقتصادية أو الكوارث المناخية، والأقل قدرة على التكيف أو الوصول إلى فرص بديلة. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي موجة حر أو فيضان إلى القضاء على مصدر رزق مزارع غير رسمي أو بائع متجول، دون أي شبكة أمان. وبالمثل، فإن الأتمتة الرقمية قد تلغي وظائف يدوية غير رسمية — كالأعمال الكتابية أو التصنيعية البسيطة — دون أن تُسجل هذه الخسائر في الإحصاءات الرسمية أو تُقترح بدائل تدريبية لهؤلاء الأفراد.
ومن هذا المنطلق، يُشدد المركز العربي للانتقال العادل على ضرورة إدماج العمالة غير الرسمية في سياسات الانتقال العادل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وبرامج التدريب لتشملهم. إذ إن عدم إشراكهم بشكل صريح قد يُسهم في تعميق الفجوات الاجتماعية الموجودة أصلًا في المنطقة. وتُعد فجوة المهارات أيضًا من أبرز التحديات. فأنظمة التعليم والتكوين المهني في العديد من الدول العربية لم تُواكب بعد التحولات المتسارعة في سوق العمل، مما أدى إلى فجوة متزايدة بين المهارات المطلوبة من قبل أصحاب العمل والمهارات المتوفرة لدى الخريجين. وقد ساهم ذلك في ارتفاع البطالة من جهة، وفي الاعتماد المتزايد على العمالة الأجنبية في بعض القطاعات التقنية من جهة أخرى.
ويُلاحظ بشكل خاص نقص الكفاءات في مجالات حيوية للتحولين المناخي والرقمي، مثل تقنيات الطاقة المتجددة، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، والزراعة الذكية مناخيًا. كما أن أنظمة التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للمهارات لا تزال ضعيفة أو شبه غائبة في معظم الدول، حيث يفتقر العديد من البلدان إلى بيانات شاملة ودقيقة عن سوق العمل، ما يُصعّب تخطيط برامج التدريب والتأهيل المهني بالشكل المطلوب. ويُعاني عدد من الدول غير الخليجية أيضًا من قيود مالية وهيكلية تحدّ من قدرتها على الاستثمار في هذا المجال.
التفاوتات الإقليمية داخل العالم العربي من المهم أيضًا الإشارة إلى التفاوتات بين دول المنطقة. ففي حين تتمتع دول الخليج ذات الدخل المرتفع مثل الإمارات، وقطر، والسعودية، بإمكانات مالية كبيرة تتيح لها الاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء (مثل محطات الطاقة الشمسية الكبرى) والبنية التحتية الرقمية (مثل شبكات الجيل الخامس)، لا تزال دول أخرى منخفضة الدخل أو متأثرة بالنزاعات، مثل اليمن، والسودان، والصومال، تعاني من ضعف شديد في البنى التحتية، حيث لا تتجاوز معدلات استخدام الإنترنت أحيانًا 30–40%، وتُركز جهودها على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، بدلًا من التخطيط للتحول طويل الأمد. أما الدول المتوسطة الدخل مثل مصر، والأردن، والمغرب، وتونس، فهي تقع في موقع وسط — حيث تُسجل معدلات مرتفعة للبطالة بين الشباب والنساء، وانتشار واسع للاقتصاد غير المنظم، ولكنها تمتلك أيضًا مجتمعات مدنية نشطة ونقابات فاعلة تسعى لإحداث إصلاحات ملموسة. ويُراعي المركز العربي للانتقال العادل هذه الفروقات الإقليمية من خلال عمله عبر شبكة الاتحاد العربي للنقابات، التي تشمل شمال إفريقيا والمشرق والخليج، بحيث يُكيّف تدخّلاته وفقًا للسياقات المحلية. ففي الدول المستقرة نسبيًا، يُركز على التأثير في السياسات العامة لإنشاء وظائف خضراء لائقة، بينما في المناطق المتأثرة بالأزمات، يُعطي الأولوية لتعزيز القدرة على الصمود، وحماية الحقوق الأساسية للعمال في ظروف عدم الاستقرار. العدالة الاجتماعية كعنصر محوري في الانتقال العادل لا يمكن فصل الأبعاد الاجتماعية للتحولين المناخي والرقمي عن قضايا الإنصاف والإدماج. فالفئات الأكثر هشاشة — مثل النساء، والشباب، والعمال المهاجرين — تواجه تحديات مركبة في هذا السياق. فالنساء في المنطقة العربية لا يتمتعن فقط بمعدلات توظيف أقل، بل يواجهن أيضًا عوائق رقمية وهيكلية (كما يظهر جليًا من الفجوة الرقمية بين الجنسين).
وإذا لم تُعتمد تدابير خاصة — مثل تشجيع الفتيات على الالتحاق بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وضمان وصول النساء الريفيات إلى أدوات الزراعة الذكية مناخيًا — فإن التحولات الجارية قد تُعيد إنتاج أوجه عدم المساواة الجندرية القائمة. أما الشباب، ورغم كونهم أكثر تأقلمًا مع التكنولوجيا، فهم بحاجة إلى مسارات واضحة تربط بين التعليم وفرص العمل الخضراء والرقمية الناشئة؛ وإلا فإن الإحباط من "نمو بلا وظائف" سيزداد. كما يجب عدم إغفال أوضاع العمال المهاجرين، الذين يُشكلون نسبة كبيرة من القوة العاملة في دول الخليج، إذ ينبغي إدماجهم في خطط الانتقال العادل — فإذا أُغلقت منشأة نفطية أو تباطأ نشاط بناء، يجب أن يحصلوا على تعويضات أو تدريب بديل، لا أن يتم ترحيلهم دون ضمانات. ومن اللافت أن نقابات من آسيا إلى المنطقة العربية بدأت في تشكيل تحالفات للدفاع عن حقوق العمال المهاجرين في سياق التغير المناخي وخطط الانتقال العادل. ويُعد الحوار الاجتماعي الذي يشمل ممثلي هذه الفئات ضروريًا لفهم احتياجاتهم وصياغة سياسات تستجيب لها. وباختصار، فإن مشهد العمل في المنطقة العربية يتميز بارتفاع البطالة، وانتشار الاقتصاد غير الرسمي، وفجوات المهارات، وعدم المساواة — وكلها تُشكل الخلفية التي ستنطلق منها التحولات المناخية والرقمية. وإن لم تُعتمد سياسات استباقية، فإن هذه التحولات قد تُفاقم التحديات القائمة؛ أما إذا تم التعامل معها بمنهج مرتكز على الإنسان، فيمكن أن تصبح رافعة لتحسين سبل العيش وتحقيق العدالة الاجتماعية
نحو انتقال قائم على الحقوق وشامل: محاور العمل الأساسية إن مواجهة التحديات المعروضة أعلاه تتطلب خيارات سياساتية متعمدة وتدخلاً منسقًا وشاملاً. ويستند إطار الانتقال العادل في المنطقة العربية إلى مجموعة من الركائز المحورية التي تضع العمال والمجتمعات المحلية في صلب التحولات المناخية والرقمية. وقد حددت النقابات العمالية، ومنظمة العمل الدولية، والوكالات الأممية عددًا من مجالات العمل الأساسية التي تُعدّ حاسمة لتوجيه هذه التحولات بما يضمن العدالة الاجتماعية والشمول.
نحو انتقال شامل قائم على الحقوق: مجالات العمل الأساسية
إن مواجهة التحديات المعروضة أعلاه تتطلب خيارات سياساتية متعمدة وتدخلاً منسقًا وشاملاً. ويستند إطار الانتقال العادل في المنطقة العربية إلى مجموعة من الركائز المحورية التي تضع العمال والمجتمعات المحلية في صلب التحولات المناخية والرقمية. وقد حددت النقابات العمالية، ومنظمة العمل الدولية، والوكالات الأممية عددًا من مجالات العمل الأساسية التي تُعدّ حاسمة لتوجيه هذه التحولات بما يضمن العدالة الاجتماعية والشمول.
- 1. الحوار الاجتماعي والمشاركة التشاركية تتطلب استراتيجيات الانتقال الفعّال مشاورات مجدية مع المنظمات العمالية وكافة الأطراف المعنية. وتؤكد المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية، كما يشدد الاتحاد الدولي للنقابات، على أن السياسات المناخية والرقمية ينبغي أن "تُكرّس حقوق الإنسان والعمل، وتعزز المشاركة التشاركية في صياغة السياسات". ويعني ذلك ضرورة اعتماد حوارات ثلاثية منتظمة بين الحكومات وأصحاب العمل والنقابات، لصياغة خطط وطنية شاملة. فعلى الصعيد العملي، يُسهم الحوار الاجتماعي في استشراف التغيرات في سوق العمل، والتفاوض حول برامج التدريب أو إعادة التوطين للعمال المتأثرين، وضمان دعم مجتمعي أوسع للإصلاحات. ويولي المركز العربي للانتقال العادل أولوية قصوى لعقد هذه الحوارات — مثل تنظيم مؤتمرات إقليمية حول العمل والسياسات المناخية — لتمكين النقابات العربية من التأثير في خطط التنمية الوطنية والمفاوضات الدولية. وقد تجلى ذلك مؤخرًا من خلال مشاركة الاتحاد العربي للنقابات في مؤتمر الأطراف COP28 بدبي، حيث دعا ممثلو النقابات إلى إنشاء برنامج عمل حول الانتقال العادل يُبقي قضايا العمال في صلب المفاوضات المناخية العالمية. وبتأسيس مشاركة مؤسسية لصوت العمال في صنع القرار، تتمكن الدول من تصميم انتقالات عادلة تحظى بقبول شعبي واستقرار اجتماعي.
- 2. تعزيز الأطر القانونية والسياساتية ينبغي على الحكومات دمج مبادئ الانتقال العادل في قوانينها الوطنية، وأنظمتها، وأطرها التنموية. ويشمل ذلك مراجعة قوانين العمل، والتشريعات البيئية، واستراتيجيات الاقتصاد الرقمي، لضمان أن تتضمن حماية حقوق العمال وتعزيز العمل اللائق. فمثلًا، عند تحديث الدول لمساهماتها المحددة وطنيًا (NDCs) في إطار اتفاق باريس، أو عند إعداد استراتيجيات للاقتصاد الأخضر، يجب أن تتضمن هذه الوثائق بشكل صريح التزامات بخلق فرص عمل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتوفير التدريب على المهارات المستقبلية — وهي مطالب كررتها باستمرار كل من ATUC وITUC. وقد حققت بعض الدول العربية تقدمًا ملموسًا — إذ تبنت كل من الأردن والإمارات والسعودية تشريعات جديدة توسع الحماية العمالية لتشمل فئات غير تقليدية مثل المستقلين والعاملين عبر المنصات الرقمية، ما من شأنه تعزيز حقوقهم في بيئة العمل الرقمي. كذلك بدأت بعض الدول عند صياغتها لقوانين المناخ بإدراج مفاهيم الانتقال العادل — على سبيل المثال، تضمّن مخطط المناخ الجزائري إشارات إلى دعم العمال المتأثرين بالتحول الأخضر. ويساعد المركز العربي للانتقال العادل في هذا المجال من خلال إعداد دراسات سياساتية، وتبادل الممارسات الدولية الفضلى — مثل تجربة آلية الانتقال العادل الأوروبية، أو الإطار الجنوب أفريقي لانتقال الطاقة. ومن الضروري أيضًا فرض المعايير العمالية في القطاعات الناشئة، لضمان أن تكون الوظائف الخضراء وظائف لائقة، توفر أجورًا منصفة، وظروف عمل آمنة، وحقوق نقابية. فبدون بنية قانونية قوية، حتى أفضل الخطط قد تفشل عند التنفيذ.
- 3. الشمول الرقمي والبنية التحتية إن سد الفجوة الرقمية شرط أساسي لتحقيق انتقال عادل وشامل. فعلى الرغم من التقدم المحرز، لا يزال نحو 30% من سكان المنطقة غير متصلين بالإنترنت، كما أن العديد من الأفراد يفتقرون إلى الوسائل التقنية (أجهزة، نطاق ترددي، إلخ) التي تُمكّنهم من المشاركة الفعلية في الاقتصاد الرقمي. ويستلزم الأمر استثمارات كبيرة في بنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خصوصًا في المناطق الريفية المحرومة والدول الأقل نموًا، حتى يُصبح الإنترنت السريع متاحًا للجميع على غرار الكهرباء والماء. ويكتسي الاستثمار في التثقيف الرقمي وتنمية المهارات الرقمية أهمية مماثلة، لا سيما لدى الفئات المهمشة مثل النساء، والفئات ذات الدخل المحدود، وسكان المناطق النائية. وقد حذرت الأمم المتحدة (UNDP) من أن التغلب على "الإقصاء الرقمي" يتطلب جهدًا جماعيًا لتكريس الحق في التمكين الرقمي وعدم ترك أحد خلف الركب. وفي هذا السياق، يدعو المركز العربي للانتقال العادل إلى اعتماد استراتيجيات وطنية رقمية ترتكز على ضمان الوصول الشامل، والأسعار الميسرة، وسد الفجوة الجندرية. وقد يشمل ذلك دعم نقاط الإنترنت العامة، وتوفير أجهزة للطلاب في المناطق المحرومة، وتنظيم برامج تدريب مجتمعية. ولا يُعد الشمول الرقمي مجرد قضية عدالة؛ بل هو أيضًا عامل حاسم في تعزيز مرونة الاقتصاد. فخلال الجائحة، استطاعت الدول ذات البنية التحتية الرقمية الأفضل أن تواصل التعليم والخدمات الاقتصادية، بينما تراجعت دول أخرى بشكل أكبر. ومن ثم، فإن ضمان قدرة الجميع على الاستفادة من التحول الرقمي سيكون هو الفيصل بين مستقبلٍ أكثر عدالة، وآخر أكثر تهميشًا.
- 4. العمل اللائق وتوفير الوظائف الخضراء إن أحد الأهداف الجوهرية للانتقال العادل هو خلق وظائف جديدة في قطاعات مستدامة، مع الحفاظ على الوظائف القائمة وتحسين جودتها. وكما سبق أن تم التطرق إليه، فإن الإمكانات كبيرة — حيث يمكن توليد ملايين الوظائف في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والزراعة المستدامة، والصناعات الخضراء، شريطة توفر السياسات والاستثمارات المناسبة. وتحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات استباقية، تشمل: ● استثمارات عامة وخاصة متماشية مع أهداف المناخ، ● حوافز للشركات الخضراء (مثل التخفيضات الضريبية أو تمويل المشاريع النظيفة)، ● وتطوير سلاسل التوريد المحلية للبنية التحتية الخضراء. ومع ذلك، فإن عدد الوظائف وحده لا يكفي — فالجودة هي الأساس. وقد دعا الاتحاد الدولي للنقابات إلى تعزيز الطموح المناخي "مقرونًا بإجراءات انتقال عادل" من أجل خلق وظائف نوعية. ويعني ذلك أن كل وظيفة جديدة يجب أن تحترم أجندة العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية — من حيث الأجر الكافي، وظروف العمل الآمنة، والأمان الوظيفي، واحترام الحقوق الأساسية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تركيب الألواح الشمسية أو توسيع شبكات النقل العام إلى خلق آلاف فرص العمل للمهندسين والفنيين وعمال البناء؛ وإذا ما تم ذلك وفقًا لمعايير واضحة، يمكن أن تكون هذه الوظائف مستقرة ورسمية، بدلًا من أن تكون مؤقتة أو هشة. ويعمل المركز العربي للانتقال العادل مع النقابات الأعضاء على: ● تحديد القطاعات ذات الأولوية لتوليد وظائف خضراء (مثل الطاقة الشمسية في تونس والأردن، أو طاقة الرياح في المغرب، أو السياحة البيئية في مصر)، ● والدعوة إلى تبني سياسات داعمة لتلك القطاعات، ● كما يُشجّع النقابات على تنظيم العمال في القطاعات الخضراء الناشئة منذ بدايتها، لضمان حماية حقوقهم من اللحظة الأولى.
- 5. التعليم، إعادة التأهيل، والتعلّم مدى الحياة في ظل التحولات المتسارعة، يُعد تطوير المهارات المستمر أحد أبرز العوامل الحاسمة لتحقيق انتقال عادل. فالعديد من الوظائف الحالية ستتغير أو تختفي، وستظهر مهن جديدة تتطلب كفاءات مختلفة أو محدثة. ولهذا، فإن هناك حاجة إلى برامج إعادة تدريب واسعة النطاق لمساعدة العمال في الصناعات المتراجعة (مثل الوقود الأحفوري أو بعض الصناعات التحويلية) على الانتقال إلى القطاعات الناشئة (كالطاقة المتجددة والخدمات الرقمية). على سبيل المثال: ● قد يحتاج عمال البناء إلى التدريب على تقنيات البناء الصديق للبيئة، ● وقد يتحوّل فنيّو النفط إلى تقنيين في الطاقة الشمسية أو الحرارية الأرضية، ● وقد يتعين على الموظفين الإداريين تطوير مهارات رقمية للعمل في التجارة الإلكترونية. وتؤكد منظمة العمل الدولية أن العديد من المهارات الحالية قابلة للتحويل — مثل مهارة حل المشكلات التي يتمتع بها الفني، سواء في إصلاح محرك ديزل أو سيارة كهربائية — لكن غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى رفع الكفاءة (upskilling). ولتحقيق ذلك، ينبغي على الحكومات: ● الاستثمار في إصلاح نظم التعليم والتكوين المهني (TVET)، ● تحديث المناهج لتشمل المهارات الخضراء والرقمية على حد سواء، ● وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والنقابات، لتوفير التدريب العملي. كما يجب تطوير أنظمة استشراف سوق العمل (forecasting systems) لتحديد المهارات المطلوبة مستقبلًا، وتوجيه التدريب بناءً عليها، وهو أمر لا يزال ضعيفًا في أغلب الدول العربية. ويُولي المركز العربي للانتقال العادل أهمية خاصة لمفهوم التعلّم مدى الحياة، ويشجع على وضع سياسات تجعل التدريب وإعادة التأهيل متاحًا في جميع مراحل الحياة المهنية، بما في ذلك للعمال الأكبر سنًا الذين قد يكونون أكثر عرضة للإقصاء. وتُبرز الدراسات الإقليمية الحديثة حول إزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن السيناريوهات المثلى تقوم على: ● الاستثمار القوي في رأس المال البشري والتعليم، ● ومرافقة عملية التحول بسياسات دعم اجتماعي للمتضررين، ● وربط التعليم بسوق العمل من خلال التدريب المهني الموجه. وباختصار، فإن تمكين القوى العاملة من خلال التعليم والتدريب ليس ترفًا، بل هو ركيزة لا غنى عنها للانتقال العادل. 6. الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة بطبيعة الحال، تفرز التحولات — لا سيما في مراحلها الأولى — رابحين وخاسرين، وتتطلب العدالة أن نُخفف من وطأة التكاليف على من يتضررون. ولهذا، تُعتبر أنظمة الحماية الاجتماعية المتينة من أعمدة الانتقال العادل. وتُطالب النقابات حول العالم بأن تُدرج الحماية الاجتماعية الشاملة — بما في ذلك التأمين ضد البطالة، والرعاية الصحية، والمعاشات — في صلب الخطط المناخية الوطنية. وفي السياق العربي، حيث تنتشر العمالة غير الرسمية والهشة، فإن توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية أمر حيوي. ويمكن أن يشمل ذلك: ● آليات مبتكرة مثل برامج دعم البطالة في حالات فقدان العمل المرتبط بالمناخ، ● أو دعم سبل العيش في المجتمعات المتضررة من الكوارث المناخية (فيضانات، موجات جفاف...). ويُعد توفير التمويل الكافي لهذه التدابير أمرًا أساسيًا. وفي COP28، طالبت النقابات بإنشاء تمويل مخصص للانتقال العادل ضمن آليات تمويل المناخ — مثل استخدام صندوق الخسائر والأضرار الجديد لدعم العمال في إعادة بناء سبل عيشهم. لكن الدعم المالي وحده لا يكفي. فالفئات الهشة تحتاج أيضًا إلى برامج مُوجهة ومتكاملة. مثلًا: ● يجب أن تحصل النساء العاملات على فرص لإعادة التدريب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والمهن الخضراء، ● ويجب أن يحصل الشباب على برامج تدريبية ومهنية لولوج القطاعات الجديدة، ● كما ينبغي أن يتلقى العمال المهاجرون معاملة متساوية في برامج الدعم — فإذا توقف مشروع إنشائي يوظف عمالًا مهاجرين لأسباب مناخية، يجب أن يحصلوا على تعويض أو تدريب، وليس على إنهاء تعسفي لعقودهم. كما أن المجتمعات المعتمدة على صناعات ملوّثة محددة (مثل مدن التعدين أو النفط) ستحتاج إلى خطط تنمية إقليمية بديلة لتنويع اقتصاداتها. ويُجسد مفهوم "عدم ترك أحد خلف الركب" — وهو أحد المبادئ الأساسية لأجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة — جوهر سياسات الانتقال العادل.
دور المركز العربي للانتقال العادل
ويعمل المركز العربي للانتقال العادل مع منظمات أممية مثل منظمة العمل الدولية والإسكوا على: ● الدعوة لتوسيع آليات الإدماج الاجتماعي، ● ومساعدة النقابات على تطوير مقترحات عملية — كإقرار أرضيات حماية اجتماعية أو إنشاء صناديق للانتقال العادل — وتقديمها إلى الحكومات ضمن أجندات الحوار الاجتماعي. وتكمن الاختبار الحقيقي لنجاح التحولين المناخي والرقمي في مدى قدرتهما على تعزيز العدالة الاجتماعية، لا في تعميق أوجه التفاوت القائمة دور المركز العربي للانتقال العادل في خضم هذه التحديات المتعددة الأبعاد، يبرز المركز العربي للانتقال العادل كجهة فاعلة مؤسسية محورية تقود أجندة الانتقال العادل في المنطقة العربية من منظور يرتكز على حقوق العمال. وقد أُنشئ المركز بمبادرة من الاتحاد العربي للنقابات، وبالشراكة مع عدد من الاتحادات النقابية العالمية، ليكون بمثابة منصة إقليمية متخصصة في البحث، والدعوة، وبناء القدرات في قضايا الانتقال العادل، بما يشمل التحول المناخي والرقمي معًا. وتتميز عمليات المركز بطابع عملي وغير ترويجي، يركز على التغيير المنهجي وتمكين العمال. ويضطلع بدور مزدوج كمحفّز للتغيير من جهة، وكداعم للنقابات من جهة أخرى، عبر أربعة محاور رئيسية:
- 1. دعم النقابات الأعضاء يُقدم المركز مساعدة تقنية وموارد تدريبية للنقابات المنضوية تحت مظلة الاتحاد العربي للنقابات (ATUC)، والتي تمثل ملايين العمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويهدف ذلك إلى تعزيز قدراتها في فهم ومعالجة التحديات المناخية والرقمية، والتأثير الفعّال في السياسات العامة. وتشمل أنشطة الدعم: ● تدريب القادة النقابيين والنشطاء على سياسات المناخ والرقمنة؛ ● توفير أدوات تحليل السياسات والتخطيط الاستراتيجي؛ ● دعم التفاوض بشأن إدخال التكنولوجيا في أماكن العمل؛ ● تحليل آثار اللوائح البيئية الجديدة على القطاعات الإنتاجية. فعلى سبيل المثال، نظم المركز ورشات تدريبية حول سياسات الطاقة المتجددة، وآليات الدفاع عن العمل اللائق في القطاعات الخضراء، مما مكّن النقابيين من تقديم مقترحات ملموسة مثل اتفاقيات للانتقال العادل عند إغلاق منشآت، أو مداخلات في الاستراتيجيات الرقمية الوطنية لحماية مصالح العمال.
- 2. تعزيز الحوار الاجتماعي وبناء التحالفات تماشيًا مع روح الانتقال العادل، يولي المركز أهمية قصوى لـالحوار البنّاء والمشاركة التعددية. ويعمل كحلقة وصل بين مختلف أصحاب المصلحة — من نقابات، وحكومات، وأرباب عمل، ومنظمات مجتمع مدني — من أجل صياغة رؤى مشتركة لمستقبل العمل والتحول الاقتصادي. وقد شارك المركز في تنظيم مؤتمرات إقليمية بالشراكة مع مكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، جمعت خبراء من القطاعات الحكومية والنقابية والمدنية. ومن أبرز هذه الفعاليات، المنتدى الإقليمي الذي انعقد في عمّان عام 2024 بعنوان: "دور النقابات في الانتقال العادل في المنطقة العربية"، والذي أتاح مساحة لتبادل التجارب الوطنية وبحث أطر الشراكة الاجتماعية في إدارة التحولات. كما يشجع المركز على تبادل الخبرات جنوب-جنوب، من خلال ربط النقابيين العرب بنظرائهم من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ممن يواجهون تحديات مماثلة، بما يُسهم في بناء شبكات دعم إقليمية وعالمية. ومن خلال هذا العمل، يسعى المركز إلى كسر الحواجز بين الحركة النقابية والفاعلين في المجال البيئي والتكنولوجي، وبناء تحالفات أوسع من أجل التغيير المنصف.
- 3. البحث وتوثيق الممارسات الفضلى يُعد المركز مرجعًا معرفيًا في قضايا الانتقال العادل في العالم العربي، حيث يضطلع بإجراء أبحاث وتحليلات قطاعية حول آثار السياسات المناخية والرقمية على التشغيل، وحالة الوظائف الخضراء في الاقتصادات العربية، وفجوة المهارات الرقمية، ودراسات مقارنة عن تجارب الانتقال. ومن خلال إنتاج تقارير موجزة وأوراق سياسات، يهدف المركز إلى سد الفجوات المعرفية، وتوفير أدلة ملموسة لدعم المناصرة والنقاش المؤسسي. ومن بين الأمثلة: ● توثيق كيف أسفر الحوار الاجتماعي في قطاع الطاقة بتونس عن خطة تدريجية لإغلاق مناجم الفوسفات، مع ضمان حقوق العمال؛ ● واستعراض تجربة ناجحة في سلطنة عمان لإعادة تدريب العمال على المهارات الرقمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات. ويعتمد المركز على أحدث البيانات المتوفرة من مصادر موثوقة، منها: منظمة العمل الدولية، الاتحاد الدولي للنقابات، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية. ويُركّز المركز في عمله البحثي على التحليل المؤسسي القائم على الأدلة، بعيدًا عن الخطابات العامة، بما يُعزز مصداقيته كشريك سياساتي رصين.
- 4. الانخراط في المنتديات الدولية رغم طابعه الإقليمي، يحرص المركز على الحضور الفاعل في الساحة الدولية، لإسماع صوت العمال العرب في المفاوضات العالمية، واستقطاب الدعم الفني والمؤسسي لمبادرات الانتقال العادل في المنطقة. يرتبط المركز بعلاقات وثيقة مع مركز الانتقال العادل التابع للاتحاد الدولي للنقابات (ITUC Just Transition Centre)، الذي أُسس في عام 2016 لدفع الأجندة النقابية العالمية في قضايا المناخ، ويشارك ضمن وفود الحركات النقابية في فعاليات كبرى، منها مؤتمرات الأطراف (COPs) الخاصة بالمناخ. وفي COP27 وCOP28، شارك ممثلو الاتحاد العربي للنقابات والمركز العربي في جلسات حوارية ونقاشات جانبية، عرضوا خلالها تحديات العمال العرب في مواجهة التغير المناخي، وسلطوا الضوء على قضايا مثل الإجهاد الحراري في أماكن العمل، وضرورة إدراج مكوّن "الانتقال العادل" ضمن التمويل المناخي للدول النامية. كما شارك المركز في فعاليات اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية لعام 2024، حيث استعرض الأمين التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات الرؤية الإقليمية حول العدالة في التحول المناخي، إلى جانب مسؤولين من الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية. وتُتيح هذه المشاركات: ● رفع الوعي الدولي بالتحديات الخاصة بالمنطقة؛ ● تعزيز تبادل المعرفة بين الشمال والجنوب؛ ● توجيه السياسات الأممية نحو مزيد من الاستجابة للسياق العربي؛ ● ربط أجندة المركز بأهداف التنمية المستدامة — لا سيما الهدف 13 (العمل المناخي)، والهدف 9 (الابتكار والصناعة)، والهدف 8 (العمل اللائق)، والهدف 10 (الحد من أوجه عدم المساواة).
وبفضل هذه الشراكات، يعزز المركز العربي قدرته المؤسسية عبر التعاون مع هيئات مثل: ● الاتحاد الدولي للنقابات، ● مؤسسة المناخ الإفريقية، ● مبادرات الأمم المتحدة ذات الصلة بالانتقال العادل. نحو مستقبل عربي رقمي، أخضر وعادل
نحو مستقبل عربي رقمي، أخضر وعادل يُشكّل التقاطع بين التحولين المناخي والرقمي في المنطقة العربية فرصة تاريخية لإعادة صياغة نموذج التنمية نحو مزيد من الاستدامة والعدالة. لكن هذه الفرصة لن تتحقق ما لم تتم إدارة التحولين بطريقة قائمة على الحقوق، وشاملة، وعدالة اجتماعية. إن منهجية "الانتقال العادل"، التي يتبناها المركز العربي للانتقال العادل وغيره من الفاعلين المؤسسيين، تقوم على مبدأ جوهري مفاده أن التقدم الاقتصادي لا ينبغي أن يتم على حساب التماسك الاجتماعي أو الإنصاف. بل يجب توظيف العمل المناخي والابتكار improve الرقمي لتحسين نوعية الحياة، وخلق وظائف لائقة، وتوسيع نطاق الحقوق، وتقليص مواطن الضعف والهشاشة. ويقتضي هذا النهج تبني سياسات متكاملة تتضمن أحكامًا قوية في مجال العمل والحماية الاجتماعية، مدعومة بالبيانات والتمويل وآليات التنفيذ. وقد أبرز التحليل الوارد في هذا التقرير أن الاقتصادات العربية، رغم تنوعها، تتقاسم تحديات بنيوية مشتركة، تشمل: ارتفاع معدلات البطالة، وانتشار العمل غير المنظم، وفجوات المهارات، وعدم المساواة الجندرية والطبقية. ويمكن أن تتفاقم هذه التحديات إذا تُركت التحولات المناخية والرقمية لتُدار بمنطق السوق فقط. لكن، في المقابل، وباعتماد تدابير استباقية — مثل تعزيز الحوار الاجتماعي، وتطوير الأطر القانونية، وضمان الإدماج الرقمي، والاستثمار في الوظائف الخضراء، وإصلاح التعليم، وتوسيع الحماية الاجتماعية — يُمكن لهذه التحولات أن تصبح رافعة لإعادة هيكلة اقتصادية عادلة. إن نجاح هذه العملية لا يكمن فقط في خفض الانبعاثات أو تعزيز التكنولوجيا، بل في تمكين المجتمعات والعمال من بناء مستقبل آمن، منتج، ومنصف. ويمكن أن تسهم هذه التحولات في إنهاء الاعتماد المفرط على قطاعات ملوثة أو نماذج إنتاج غير مستدامة، والانتقال إلى اقتصادات أكثر تنوعًا، قائمة على المعرفة، ومرتكزة على العدالة المناخية والاجتماعية. دعوة إلى العمل الدولي والتضامن المؤسسي إن دعم الانتقال العادل في المنطقة العربية ليس فقط ضرورة أخلاقية من منطلق التضامن، بل مصلحة استراتيجية للمجتمع الدولي. فالمبادئ التي نُدافع عنها هنا — ألا يُترك أي عامل خلف الركب في مواجهة تغير المناخ، وألا يُقصى أي مجتمع من ثمار التقدم الرقمي — هي مبادئ كونية. ومع سعي الدول لتحقيق أهداف اتفاق باريس وأجندة 2030 للتنمية المستدامة، تقدم التجربة العربية دروسًا هامة وتُبرز الحاجة إلى تحرك جماعي وتعاون مؤسسي. ويمكن للمنظمات الدولية أن تلعب دورًا حاسمًا من خلال: ● توفير الدعم الفني، ● تسهيل التمويل الخاص ببرامج الانتقال العادل (مثل صناديق إعادة التدريب أو برامج تنمية المجتمعات المتأثرة)، ● وضمان أن تظل اعتبارات العدالة حاضرة بقوة في منتديات السياسات العالمية، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (UNFCCC) ومنظمة العمل الدولية (ILO).
نحو تعاقد اجتماعي جديد في السنوات المقبلة، من المتوقع أن يلعب المركز العربي للانتقال العادل دورًا رياديًا في: ● رصد التقدم المحرز، ● مساءلة الفاعلين عن التزاماتهم في مجال الانتقال العادل، ● قيادة الحوار الاجتماعي المتعدد الأطراف في المنطقة. وسيبقى التركيز على المناصرة المبنية على الأدلة، وبناء الشراكات الاجتماعية، عنصرًا أساسيًا لمواجهة حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي. ورغم طول الطريق، هناك إشارات إيجابية: مثل تزايد الاعتراف بمفهوم الانتقال العادل في الخطابات والسياسات الإقليمية، وتجربة بعض المبادرات التي تجمع بين الطموح المناخي وخلق فرص العمل. غير أن نجاح هذا المسار يتطلب جهدًا متواصلًا وقيادة مؤسسية، لضمان أن تتماشى التحولات المناخية والرقمية مع أهداف العمل اللائق، والإدماج الاجتماعي، واحترام حقوق الإنسان. إن انتقالًا مناخيًا ورقميًا شاملاً ليس مجرد خيار ممكن، بل ضرورة وجودية لمستقبل المنطقة العربية. ومن خلال تركيز العملية على الناس — وخاصة الفئات المهمشة — يمكن تحويل الأزمتين المناخية والتكنولوجية إلى فرصة تاريخية لصياغة تعاقد اجتماعي جديد. ويمثل المركز العربي للانتقال العادل هذا المسار الطموح، حيث يلتقي فيه الاستدامة البيئية مع التقدم التكنولوجي، على أرضية العدالة الاجتماعية. وفي روح الأمم المتحدة والحركة النقابية العالمية، فإن نداء العمل واضح: "يجب ألا يُترك أحد خلف الركب" — ولتبنِ المنطقة العربية اقتصادًا أكثر اخضرارًا، أكثر رقمية، وقبل كل شيء، أكثر عدالةً للأجيال الحالية والمقبلة